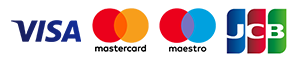بينما كنت أتصفح بعض من القصص التي كانت تحفل بها إحدى منصات التواصل الاجتماعي (الإنستغرام) خلال عطلة عيد الميلاد، صادفت قصة "صوفينا"، لقد قامت صوفينا بوضع منشور على المنصة تتحدث عن المؤسسة الخيرية التي تعمل تحت رعايتها والتي تُعرف باسم مؤسسة الإغاثة الإنسانية، حيث كان يتمحور حديثها حول طاقم من المؤسسة من المفترض أنه سيتجه إلى لبنان للمساعدة وتقديم العون للاجئين السوريين الذين أودت بهم الحياة إلى أسوأ سيناريوهاتها، وكان هناك متسع أو لربما فرصة لشخص واحد كي يسافر معهم إلى هناك، وأن أي شخص مهتم بالأمر عليها التواصل معهم، وعلى الفور قمت بالتواصل معها وسألتها عمّا إذا ما زالت الفرصة متوفرة للالتحاق بهما، ولحسن حظي لم يكن أحد قد حجز المكان قبلي، ولكي أستطيع السفر معهم كان يتوجب عليَ جمع الأموال والتبرعات بسرعة التي كانت تقدّر بـ 4000 جنيه إسترليني كحد أدنى.

سألتني صوفيا عما إذا كنت أستطيع أن ألتقي بها في اليوم التالي في أحد مكاتب مؤسسة الإغاثة الإنسانية في برمنغهام، حيث ستكون هناك هي ووسيم إقبال الذي يعمل رئيسًا لعمليات التوزيع الدولية لكي يقوموا بإطلاعي على أدق التفاصيل التي سنقوم بها، ولكي يساعدونني أيضًا في إيجاد سبل للبدء بجمع التبرعات.
تلك كانت أولى خطواتي في هذه الرحلة، رسالة واحدة كانت كفيلة بتغيير مسار حياتي كُليًا.
في هذا الوقت كان زوجي مسافرًا إلى تركيا، ليسفوس، "ذا جانجل" وغيرها من الأماكن المختلفة لأجل تقديم المساعدة للاجئين الذين انتهى بهم الأمر للعيش في مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، حيث فُرض على اللاجئين أن يقضوا بين جوانبها العديد من سنوات الشقاء، كنت دائمًا أفكر به وأنه لا بد أنه سيعود وذاكرته محملة بالقصص التي تُدمي القلب وسيسردها لي شيئًا فشيئًا، لطالما كانت لديّ رغبة مُلحة في مرافقته، ولكن بسبب أطفالي وعملي المرهق نوعًا ما كان دائماً من الصعب إيجاد وقت لذلك، ودومًا كان يتملكني هاجس من القلق ما إذا كنت سأنسجم مع الأشخاص الذين سوف أرافقهم، وفيما إن كنت سأستطيع مواصلة العمل أم سأنسحب في منتصف الطريق، وهل يا تُرى سوف أتفق مع الطريقة التي سيتبعونها في إنجاز المهام وغيرها من الأمور الأخرى.
لذلك عندما ذهبت إلى أحد مكاتب مؤسسة الإغاثة الإنسانية في برمنغهام، كان من دواعي الدهشة والسرور أن أجلس مع بعض الفريق تابع تلك الصفحة التي كنت أتابعها مثلي تمامًا، كل ما كنت حقًا أهدف إليه هو أن أقدم المساعدة على قدر ما أستطيع، وهم بالطبع سوف يكونون إلى جانبي، ومع ذلك كان شعور الخوف دومًا ما يدق ناقوسه، ويخيم عليّ بين الحين والأخر، لأنني مدركة تمامًا أنها سوف تكون رحلة محفوفة بالعواطف والمشاعر المُدججة، ولكن لم يأخذني التفكير بأن تلك الرحلة ستترك بصمتها على حياتي للأبد.
بعد أن هبطت طائرتنا على أراضي بيروت، التقينا ببقية أعضاء الفريق، إذ كنا أحد عشر فردًا، البعض كانت له تجربة سابقة في عمليات التوزيع، والبعض كانت تلك تجربته الأولى في هذا الأمر، أثناء طريقنا من المطار إلى الفندق، استهل وسيم حديثه معنا بلمحة عن كيف انتهى الأمر باللاجئين في لبنان، وما هي الحاجات الأساسية المتوفرة لهم، وما هي الحاجات التي يفتقرون إليها ويعانون من نقصها، وأيضًا تحدث بعض الشيء عن الوضع العام لديهم، التقينا أيضًا ببديع غزاوي، الذي يعمل مع جمعية الرعاية الإسلامية وهو الممثل اللبناني لمؤسسة حقوق الإنسان الخيرية، وهو المسؤول عن الجوانب اللوجستية لتوزيع المساعدات، وأيضًا فوجئت بوجود قاسم طوقان المسؤول التنفيذي في مؤسسة الإغاثة الخيرية الذي سيكون معنا أثناء توزيع المساعدات والوقود على اللاجئين.
بعد الليلة الأولى لنا هناك، بدأنا بأول الطرق في رحلتنا، حيث سرنا على طول سهل البقاع متجهين إلى المخيم الأول، وهو في بلدة فقيرة مهمشة على الحدود السورية واللبنانية، أثناء الطريق، شرح لنا وسيم وبديع مدى أهمية وإنسانية ما نحن مقدمون عليه هناك، وأننا يجب أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وأن نقوم بالتزاماتنا، ونقدم ما ينتظره اللاجئون منا، أولئك الأشخاص الذين صادفتهم برحلتي، كانوا مثلنا تماما، لديهم بيوتهم ووظائفهم وعائلتهم وأصدقاؤهم، بمعنى آخر كانت حياتهم مثلنا تمامًا، ولكن شاء القدر أن يُسلب منهم كل شيء، وهم ليس بأيديهم من الأمر شيء، ولكنهم حافظوا على ما هو الأثمن في حياتهم على الإطلاق، ألا وهو كرامتهم الإنسانية، من نظري الأمر الأكثر أهمية هو الطريقة التي تقدم بها المساعدة للناس، يجب أن نحرص دائمًا أن تُكلل المساعدة التي نقدمها للأشخاص بابتسامة عريضة لا تدع فرصة للشعور بالصغر أو الشفقة أن يتسرب إليهم، بل علينا أن نشكرهم، لأنه حين نقدم لهم المساعدة يمنحونا تلك الدعوات والصلوات النابعة من قلوبهم وهذا الأَجَلُّ والأنبل، تخيل للحظة لو وضعتنا الحياة في موقفهم نفسه، يا تُرى ما الشعور الذي سيخيم علينا حين يُقدم لنا العون؟

عندما وصلنا إلى المخيم، دُهشت بما رأيته من المنازل المهجورة المترامية بين جوانب تلك المنطقة الجبلية الباردة والكئيبة، وبين هذه المنازل غير المأهولة كانت هناك أعداد كبيرة من الخيام المشمعة البيضاء التي تمتد على مرمى البصر، هذا ما لم أكن أتخيله أبدًا، حيث كنت أتوقع رؤية خيام مثل تلك التي تظهر في الأخبار التلفزيونية.
كان البرد القارص يسيطر على الأجواء هناك حين بدأنا بتجهيز المواد الغذائية والوقود لأجل توزيعها على اللاجئين، وتم تقسيم المساعدات مُسبقًا بشكل منظم ودقيق، لا بد أن تتسم عمليات التوزيع بالتنظيم الدقيق، وذلك لأجل توفير الوقت الذي يصطف فيه اللاجئون في طوابير طويلة، حيث لا تغطي أجسادهم سوى ملابس رقيقة، وأحذية بالية، ربما تزيد من شعورهم بالبرد ولا تحميهم منه، وحالما يتم تجهيز المواد للتوزيع سيتم استدعاء اللاجئين، وتوزيع الطعام والوقود عليهم.
لا يمكن أن أنسى تلك الابتسامات النقية والأدعية الطاهرة وعبارات الشكر التي كانت نابعة من قلوب الناس. لا يغادر ذاكرتي مشهد الأطفال الذين كانوا حولنا في كل مكان يمارسون أبسط حقوقهم باللعب، حيث كانت ترتسم على وجوههم الابتسامات الأنقى على الإطلاق، على الرغم من أنهم بالكاد يشعرون بالدفء بسبب تلك الأحذية البالية التي يلبسونها، ومن ثم ذهبنا إلى العائلات في خيامهم، واستمعنا إلى قصصهم المفجعة. كيف نجا وهرب هؤلاء الأشخاص من الحرب، وكيف فقدوا أحباءهم، منهم من فقد أمه، أو أباه، أو شقيقه، والبعض خسر عائلته بالكامل.
قصص مروعة لأناس فقدوا أطرافهم، وأطفالهم ماتوا من القنابل العمياء التي وضعت حدًا لحياة أطفال لم يحيوا بعد، ومن نجا منهم ما زال عالقًا في المخيمات الآن.
في الحقيقة لم تكن المخيمات على قدر النظافة التي تصلح للعيش فيها، والخيام لا تمنح الدفء، بل يتضاعف فيها البرد بمساحاتها الصغيرة التي لا تتجاوز 10 أقدام مربع، لا أستطيع وصف حال هؤلاء الأشخاص العالقين بين مطرقة المخيم وسنديان الذكريات الأليمة التي تكاثفت لسنوات عديدة، كل هذا وهم عالقون لا يجدون سبيلاً للعودة كالسابق أو المضي قدمًا، هناك ثلة قليلة من المدارس، ولكن ليس هناك محلات تجارية، الأطباء والمستشفيات تبعد مسافات طويلة عن المخيم، ما يخلق صعوبة كبيرة في الوصول إليهم، كما لا يُسمح لهم بالعمل، وهم بالفعل محرومون من الوظائف، هم بالفعل يعانون أزمة مالية لا نهاية لها.
نحن في القرن الحادي والعشرين، من المفترض أن نكون على قدر من الإنسانية والتعاطف والرحمة التي لا تسمح لأي من هذا أن يحدث على كوكب الأرض؟
لقد قابلت العديد من العائلات والأشخاص المكلومين، ولكن هناك عائلة واحدة لا زلت أذكر لقائي معها بكامل تفاصيله، وسيبقى محفورًا بذاكرتي، عائلة تتألف من سيدة أرملة تقوم على رعاية ستة أطفال، حيث نفد كل الوقود والطعام الذي كان لديهم قبل يوم واحد من وصولنا، لقد قضت السيدة ليلتها كاملة داعية ومتضرعة إلى الله، فهي لا تملك بيدها من الأمر شيء سوى الدعاء، ولدى وصولنا في اليوم التالي مع الوقود والمساعدات الغذائية، أول ما تفوهت به لنا بأن الله قد استجاب دعاءها، وربما كانت الملائكة تحف المكان التي كانت فيه، الشعور الذي تملكني حينها لا أستطيع وصفه، كان لأول مرة يخيم عليّ مثل هذا الشعور، كان يشدني التفكير بماذا كان سيحل بهذه الأسرة والآلاف غيرها لو لم نتمكن من جمع التبرعات من الجهات المانحة وقدمنا لهم المساعدات؟
بالنسبة لنا نحن نصرف بعض النقود على العديد من الكماليات التي لا نلقي لها بالًا مثل شراء الحلويات وبعض السجائر والخروج للتنزه، ولكن قد تكون هذه النقود تمثل مسألة حياة أو موت لأشخاص آخرين. القصص التي قابلناها كثيرة وموجعة للغاية، ولا أستطيع سردها بسبب ما تخلقه من ألم في الروح.
لقد قضينا أربعة أيام في زيارة العديد من المخيمات وتقديم المساعدات لهم، ولكن هذه ليست بالفترة الكافية. هذه الرحلة وضعت بصمتها على حياتي للأبد، لدرجة أني شعرت أن رسالتي الآن في هذه الحياة هي مساعدة أولئك المنسيين الذين يقطنون بين أزقة الحياة الضيقة، أنا لا أقدم هذا لأجل شهرة أو مجد أو غيره، أنا أفعل ذلك لأن هذا ما تفرضه علينا إنسانيتنا، أعلم أنني لا أستطيع تغيير العالم، ولكن إذا كان بإمكاني إحداث فرق، وأني ساعدت في إنقاذ حياة شخص على الأقل، فأنا أعلم أنني قمت بواجبي، ولكن سؤالي لك الآن هل أديت واجبك الإنساني تجاههم؟